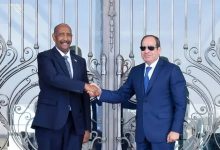صيانة القرارات المصيرية وتوزيع الموارد والصلاحيات بعدالة: الأسس الاستراتيجية لتأسيس برلمان انتقالي
بقلم : د. محمد صلاح علي الفكي

صيانة القرارات المصيرية وتوزيع الموارد والصلاحيات بعدالة: الأسس الاستراتيجية لتأسيس برلمان انتقالي
لم تعد المراحل الانتقالية في الدول الخارجة من الأزمات تُدار بالحدس السياسي أو التوازنات الظرفية، بل أصبحت – وفق أدبيات الإدارة الحديثة والإدارة الاستراتيجية – لحظات تأسيسية عالية الخطورة، تُقاس فيها كفاءة الدولة بقدرتها على بناء مؤسسات جماعية تضبط القرار، وتمنع اختطاف السلطة، وتحوّل الإرادة الشعبية إلى منظومة حوكمة قابلة للمساءلة. وفي هذا السياق، يُعدّ البرلمان – سواء كان منتخبًا أو مُعيّنًا تعيينًا انتقاليًا – أقوى كيان مؤسسي في الدولة، لأنه الحاضن الشرعي للقرار المصيري، والآلية التي تُدار عبرها الموارد والصلاحيات باسم المجتمع لا الأفراد.
تنطلق نظريات الحوكمة الرشيدة (Good Governance) والإدارة العامة الحديثة من مبدأ جوهري مفاده أن السلطة كلما تركزت خارج الأطر المؤسسية زادت احتمالات الانحراف والفساد وسوء تخصيص الموارد. ولذلك، فإن غياب البرلمان أو إفراغه من مضمونه في المرحلة الانتقالية يفتح الباب أمام إدارة البلاد بواسطة مجموعات غير معلومة التفويض، أو أفراد يحتكرون القرار، أو لجان تتضخم صلاحياتها دون أطر مساءلة واضحة، وهو ما أثبتت التجارب المقارنة أنه مدخل مباشر للأزمات الكارثية، لا مخرجًا منها.
وفقًا لأدبيات الإدارة الاستراتيجية، فإن أي كيان بحجم البرلمان يجب أن تُصمَّم آلياته بما يعكس ضخامة دوره وتعقيد مهامه. فالبرلمان ليس تجمعًا شكليًا، بل منظومة تشاركية تُبنى على أسس: وضوح الرسالة، توزيع الصلاحيات، اتخاذ القرار الجماعي، والثقة المتبادلة بين الأعضاء. وتشير نظريات اتخاذ القرار الجماعي (Collective Decision-Making) إلى أن القرارات التي تُتخذ عبر التشاور الواسع والأغلبية المؤسسية تكون أكثر استدامة وأقل عرضة للانقلاب أو الرفض المجتمعي، بخلاف قرارات الفرد أو الدوائر الضيقة التي غالبًا ما تُفتقد للشرعية والقبول.
من منظور الإدارة الانتقالية (Transitional Governance)، فإن أخطر ما يواجه الدول في هذه المراحل هو الخلط بين المؤقت والدائم. فاللجان التسييرية، وفق المنهج العلمي، تُنشأ بقرار معلن صادر من الجهة السيادية الانتقالية المفوضة أو مجلس سيادي او رئاسي انتقالي يمنح تفويض لشخصيات وطنية مهنية مستقلة خبرة عملية مثبتة في : الإدارة العامة والقانون الدستوري والاقتصاد العام وإدارة الأزمات غير راغبة في تولي مناصب لاحقة تعمل لمدة محددة مثلا 60 – 90 يوم بوصفها آليات مؤقتة لتسيير الانتقال، لا بوصفها بدائل دائمة للمؤسسات. دورها يقتصر على الإعداد، وتهيئة البيئة الإجرائية (سجل، لوائح ، ترشيحات ) الدعوة لاجتماع التأسيس الأول للبرلمان، ووضع المسارات، لا احتكار القرار أو إعادة إنتاج التسلط بصيغة جديدة. وعليه، فإن المسار السليم يبدأ بلجنة تسييرية محدودة التفويض، تُنشأ بوضوح، وتُعلن منذ البداية أن صلاحياتها تنتهي تلقائيًا عند اكتمال تكوين البرلمان الانتقالي، لتنتقل السلطة إلى هيئة تمثيلية يختار أعضاؤها – أو يكتمل اختيارهم – وفق ما يتفق عليه المجتمع وقواه الحية.
تؤكد أدبيات التخطيط الاستراتيجي أن وضوح المسار من البداية شرط لنجاح أي تحول مؤسسي. فحين يعرف الفاعلون أن القواعد ثابتة، وأن تشكيل اللجان، والأمانات، والهياكل يتم وفق ما يُتوافق عليه جماعيًا داخل البرلمان، لا بقرارات فوقية، تتراجع النزاعات، ويعلو منسوب الثقة، ويتحول البرلمان إلى ساحة تفكير وحدوي تشاركي (Participatory & Deliberative Platform)، لا إلى ساحة صراع على النفوذ.
وفي هذا الإطار، يصبح لرئيس الوزراء دور محوري، لا بوصفه صاحب قرار منفرد، بل بوصفه قائدًا تنفيذيًا يعمل تحت مظلة البرلمان، ويخضع لرقابته، ويستمد قوته من وضوح التفويض لا من غموض الصلاحيات. فالإدارة الحديثة تميّز بوضوح بين القيادة التنفيذية (Executive Leadership) والسلطة التشريعية الرقابية، وتعتبر الفصل الوظيفي بينهما شرطًا للاستقرار ومنع الاستبداد.
تعالج هذه المقاربة الاستراتيجية أوجه القصور الشائعة التي وقعت فيها دول عديدة، حيث أُديرت المرحلة الانتقالية بعقلية الطوارئ الدائمة، وتم تمديد الأجسام المؤقتة بلا سقف زمني، مما أدى إلى إطالة الأزمات بدل حلّها. ويُعدّ أسلوب اختيار أعضاء البرلمان الانتقالي من أخطر مفاصل هذه المرحلة، إذ تشير أدبيات الإدارة الاستراتيجية والحوكمة الانتقالية إلى أن جودة التمثيل لا تقل أهمية عن وجود البرلمان نفسه.
فالاختيار الرشيد للأعضاء يقوم على مجموعة اعتبارات متكاملة، في مقدمتها: التمثيل المجتمعي الواسع بما يعكس التنوع الجغرافي والاجتماعي والمهني، والكفاءة والخبرة في مجالات التشريع، والإدارة العامة، والاقتصاد، والقانون، مع إعطاء وزن خاص لأصحاب الخبرة العملية لا الرمزية السياسية فقط. كما يُعدّ الاستقلال النسبي عن مراكز النفوذ المالي أو العسكري شرطًا جوهريًا لضمان حرية القرار، إلى جانب النزاهة والسجل العام الخالي من شبهات الفساد أو الانتهاكات الجسيمة.
وتؤكد التجارب المقارنة أن آليات الاختيار الناجحة غالبًا ما تجمع بين الترشيح المؤسسي من قوى المجتمع المنظمة، والمعايير الموضوعية المعلنة، والتوازن بين الأقاليم والفئات، مع تحديد واضح لطبيعة العضوية بوصفها تكليفًا مؤقتًا لخدمة الانتقال لا تفويضًا دائمًا للسلطة. فحين تُبنى العضوية على هذه الاعتبارات، يتحول البرلمان الانتقالي إلى عقل جمعي للدولة، لا إلى امتداد لصراعاتها القديمة.
وعليه، يتم اختيار أعضاء البرلمان الانتقالي على الأسس الآتية:
التمثيل العادل للأقاليم وفق وزن سكاني وتنموي يضمن عدم هيمنة المركز.
التمثيل المهني والقطاعي (قانون، اقتصاد، إدارة عامة، تعليم، صحة، إنتاج، مجتمع مدني) لضمان جودة التشريع والرقابة.
الكفاءة والخبرة العملية المثبتة بحد أدنى من سنوات العمل والإنجازات القابلة للتحقق.
الاستقلال المؤسسي وعدم شَغل مناصب تنفيذية أو الارتباط بمصالح مالية/عسكرية مؤثرة خلال فترة العضوية.
النزاهة والسجل العام الخالي من قضايا فساد أو انتهاكات جسيمة، مع آلية تدقيق شفافة.
التنوع الاجتماعي (النوع، الشباب، الفئات الأقل تمثيلًا) دون الإخلال بمعيار الكفاءة.
الالتزام بميثاق انتقالي يحدّد الأهداف، مدة العضوية، وقواعد السلوك وتضارب المصالح.
آلية اختيار مركّبة تجمع بين الترشيح المؤسسي، التقييم الفني المستقل، والإجازة النهائية داخل البرلمان ذاته. فعدم بناء برلمان انتقالي فاعل يعني عمليًا تأجيل الحلول، وترحيل كلفة الفشل إلى الأجيال القادمة، وهو ما تعتبره الأدبيات الحديثة شكلًا من أشكال سوء الإدارة العامة وإهدار الفرص التاريخية.
وتشير التجارب الدولية الناجحة – في ضوء دراسات الحوكمة المقارنة – إلى أن البرلمانات الانتقالية بُنيت على أسس علمية واضحة: شمول التمثيل، وضوح التفويض، أطر زمنية محددة، قواعد صارمة لاتخاذ القرار، وربط مباشر بين القرار والرقابة. ففي جنوب أفريقيا، شكّل البرلمان الانتقالي بعد نهاية نظام الفصل العنصري منصة توافق وطني واسعة ضمنت عدم انزلاق الدولة إلى الفوضى، عبر اعتماد مبدأ التفاوض المؤسسي والقرار الجماعي وربط التشريع بمشروع دستوري واضح. وفي رواندا، أُعيد بناء البرلمان كأداة ضبط استراتيجي مرتبطة بخطط تنمية طويلة المدى، ما ساعد على توحيد القرار ومنع عودة الانقسام، وتحويل السلطة التشريعية إلى شريك في إعادة بناء الدولة لا مجرد مراقب شكلي. أما إندونيسيا، فقد نجحت في مرحلة ما بعد التحول عبر تقوية البرلمان وتوسيع تمثيل الأقاليم داخله، بما كبح التمركز، وخلق توازنًا بين المركز والأطراف، ومنع عودة الحكم الفردي. وتشير هذه النماذج مجتمعة إلى أن النجاح لم يكن نتاج عبقرية سياسية استثنائية، بل ثمرة التزام صارم بمنهج إداري استراتيجي يستند إلى العلم، والتجربة، والانضباط المؤسسي، واحترام القواعد التي تحكم المرحلة الانتقالية.
توصيات:
1. تأسيس برلمان انتقالي المدة الأنسب عالميًا 24 شهرًا بتفويض واضح ومعلن، يضبط القرار المصيري ويمنع تركّز السلطة خارج الأطر المؤسسية.
2. حصر دور اللجان التسييرية في الإعداد المؤقت، مع تحديد سقف زمني غير قابل للتمديد إلا بإجماع برلماني.
3. اعتماد آليات اتخاذ القرار الجماعي داخل البرلمان، بالتصويت أو التوافق، مع توثيق كل القرارات وعلنيتها.
4. الفصل الوظيفي الصارم بين السلطة التنفيذية والتشريعية، وتعزيز دور رئيس الوزراء كقائد تنفيذي خاضع للرقابة.
5. بناء الأمانات واللجان البرلمانية على أسس تشاركية، بعد اكتمال البرلمان، لا قبل ذلك.
6. ربط عمل البرلمان بخطط استراتيجية مرحلية قابلة للقياس والتقييم، وفق مؤشرات أداء واضحة.
إن تأسيس برلمان انتقالي وفق أسس الإدارة الحديثة شرط بقاء للدولة في لحظات التحول الكبرى. فالبرلمان هو الضامن لصيانة القرارات المصيرية، والآلية التي تُعاد عبرها الثقة بين الدولة والمجتمع. وكلما كان هذا الكيان تعبيرًا حقيقيًا عن المشاركة، والعدالة، والعقل الجمعي، اقتربت البلاد من الخروج الآمن من أزماتها. أما تغييب البرلمان أو إفراغه من مضمونه، فليس سوى إعادة إنتاج للفشل، مهما تغيّرت الأسماء والواجهات.:
ومن منظور الإدارة الاستراتيجية التطبيقية، لا يكتمل بناء البرلمان الانتقالي بمجرد تشكيله، بل بقدرته على التحول السريع من كيان تأسيسي إلى فاعل تنفيذي ضابط للإيقاع العام للدولة. وتشير التجارب المقارنة إلى أن أول تسعين يومًا من عمر أي برلمان انتقالي تُعدّ المرحلة الأكثر حساسية، إذ تُرسي فيها الأعراف المؤسسية، وتُختبر فيها جدية التفويض، وتتحدد العلاقة الفعلية بين السلطات. ولذلك، فإن نجاح البرلمان في هذه المرحلة يُقاس بمدى انتظام جلساته، وسرعة استكمال لوائحه الداخلية، وبناء لجانه المتخصصة، واعتماد أجندة تشريعية ورقابية محددة الأولويات، بما يمنع الانزلاق إلى حالة التأسيس المفتوح أو الجدل الإجرائي العقيم.
وتؤكد أدبيات الحوكمة الحديثة أن ربط العمل البرلماني بمؤشرات أداء قابلة للقياس يُعد شرطًا للشفافية والمساءلة. فالبرلمان الانتقالي، بوصفه كيانًا مؤقتًا عالي التأثير، يحتاج إلى أدوات تقييم واضحة، مثل انتظام دورات الانعقاد، ونسبة القرارات الموثقة والمنشورة، ومستوى التزام الحكومة بتقارير المساءلة الدورية، ومدى مواءمة التشريعات الصادرة مع الأهداف الانتقالية المعلنة. إن وجود مثل هذه المؤشرات لا يقيّد البرلمان، بل يحصّنه من التسييس، ويُحوّل الأداء من مجال للتقدير الانطباعي إلى مجال للتقييم الموضوعي.
ويجدر التأكيد، في هذا السياق، أن هذه المقاربة لا تنطلق من توصيف حالة بعينها، ولا تستهدف نموذجًا سياسيًا محددًا، بل تستند إلى مبادئ علمية عامة أثبتت صلاحيتها في سياقات انتقالية متعددة، بغض النظر عن الجغرافيا أو الخصوصيات الثقافية. فالغاية هنا ليست إعادة إنتاج تجربة بعينها، بل استخلاص القواعد المشتركة التي تحكم نجاح المؤسسات الانتقالية حين تُدار بعقل الدولة لا بمنطق اللحظة.
كما أن تحديد الأطر الزمنية لعمل البرلمان الانتقالي لا ينبغي أن يُفهم بوصفه قيدًا على الإرادة السياسية، بل باعتباره أداة استراتيجية لمنع تمدد المؤقت وتحوله إلى دائم. فغياب السقف الزمني الواضح، وفق تجارب الإدارة العامة في الدول الخارجة من الأزمات، يُفضي غالبًا إلى ترهل مؤسسي، وتآكل الشرعية، وتراجع الثقة المجتمعية، حتى وإن كانت النوايا الأولية سليمة. وعليه، فإن الزمن في المرحلة الانتقالية ليس عنصرًا إجرائيًا محايدًا، بل أحد أهم أدوات الحوكمة الرشيدة.
إن القيمة الحقيقية للبرلمان الانتقالي لا تُقاس بعدد أعضائه ولا بطبيعة تسميات لجانه، بل بقدرته على إنتاج قرار جماعي منضبط، قابل للمساءلة، ومتصالح مع الواقع، وموجّه نحو المستقبل. وكلما كان هذا الكيان محكومًا بقواعد واضحة منذ لحظة التأسيس، تحوّل من عبء انتقالي محتمل إلى رافعة استراتيجية تحمي الدولة من إعادة الدوران في حلقة الفشل المؤسسي.