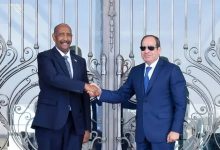صدى من وراء القضبان: الرجل الذي ذاب صوته في الأفق
كان الليل يهبط على المدينة كأبواب حديدٍ تُغلق بإحكام، وكانت الأزقة تختزن ما يشبه الهمس البعيد، همس رجلٍ ذاب صوته في الأفق حتى صار كأنه ظلّ لقطرةٍ تسقط في لجّة بحر، لا يسمعها أحد، لكنها تتمدّد في الروح إلى أن تصير موجًا غامضًا يضرب ضفّة القلب. كان ذلك الرجل هو مراد، الذي اعتاد أن يجلس كل مساء قرب النافذة الضيقة في غرفته، يحدّق في نقطةٍ ما خلف الظلام، نقطةٍ يعرف أنها ليست موجودة إلا في خياله؛ لكنه لا يملك غيرها ليقاوم بها الخطب المريع الذي طوى صدره منذ سنوات.
لم يكن مراد سجينًا بالمعنى المعروف، لكنه كان رهين سجنٍ في الكون الفسيح، كما لو أنّ العالم كلّه صار زنزانة واسعة لا يرى فيها مخرجًا. كان الناس يطالعونه ولا يرونه، يحدّثونه ولا يسمعون صمته، وكان هو يرى نفسه يتقلّب فوق فراشٍ يهزّ أساه كلّ ضمير حرّ، كما لو أنّ الألم لم يعد مجرد شعور، بل صار جسدًا آخر يتحرك في داخله ويمسك بضلوعه.
لم يكن مراد يخشى الموت؛ كان يخشى فقط أن يموت صوته نهائيًا، أن يذوب كما ذاب في لُجج الأثير، أن يختفي قبل أن يفهم أحد ما يجري داخل هذا الصدر الذي أثقلته السنين. لكنه لم يكن يعلم أنّ لحظة الحقيقة ستبدأ يوم طرق باب غرفته طارقٌ لا يعرفه، يحمل له رسالة بخطّ يد ارتعش فوق البياض كأنه كُتب في ظلمة زنزانة.
كانت الرسالة بلا اسم، بلا مقدمة.
سطر واحد فقط:
“صوتك ليس ميتًا… إنه محتجز.”
ظلّ مراد يقرأ الجملة عشرات المرات. كانت الكلمات بسيطة، لكنها تشبه تلك العناوين الجانبية التي تتسلل داخل النص العميق لتعيد ترتيب المعنى. لم يفهم كيف يمكن أن يُحتجز الصوت، لكنّه شعر بأن شيئًا ما في أعماقه اهتزّ، كأن جذوة كانت توشك أن تنطفئ ثم اشتعلت من جديد. تلك اللحظة، خطر في ذهنه وجه امرأة واحدة: فوز.
كانت فوز بالنسبة له أشبه بنور خافت في آخر نفق طويل. عرفها منذ سنواتٍ في ساحة الجامعة؛ كانت لها ضحكة تحمل شيئًا من حياةٍ لم يعشها بعد، وكان قلبه يزداد ارتباكًا كلما سمعها. لكنها اختفت قبل أن يخبرها بشيء، اختفت كما يختفي الطائر الذي يبحث عن غابة أخرى حين تُهدم الأعشاش ولا تهزج له أنغام. ومنذ ذلك اليوم، أخذت وحشة ما تبني جدارًا داخل صدره.
ولكن لماذا يتذكرها الآن؟
لماذا ارتبط ظهور الرسالة بها؟
في تلك الليلة، لم يُغلق مراد عينيه. كان يسمع صوتًا يشبه الصليل، ليس صليل قيدٍ حديدي، بل صليل ما هو أثقل: صليل الخوف. وعندما اقترب الفجر، نهض فجأة وكأنه تأخر عن موعدٍ كان يجب حضوره منذ سنوات.
خرج إلى الشارع، والشمس لم تشرق بعد، لكنه شعر أن الخطوات التي يسيرها ليست خطواته، بل خطوات شيء بداخله يستيقظ بعد غياب. اتجه نحو الحي القديم، حيث كان يقطن رجلٌ عجوز يقال إنه يعرف أسرارًا لا يجرؤ أحد على نطقها. كان الناس يسمونه الشيخ نجاة؛ لا أحد يعرف اسمه الحقيقي، لكنه كان يظهر دائمًا في اللحظة التي يوشك فيها أحدهم على الانكسار.
فتح الشيخ الباب قبل أن يطرقه مراد، وقال بصوتٍ خافت كأنه صدًى من زمن آخر:
“أخيرًا جئت… صوتك يصرخ منذ زمن.”
جلس مراد متوجسًا، وأخبره بالرسالة.
ابتسم الشيخ ابتسامة غامضة، وقال:
“ما يُحتجز ليس الصوت يا مراد… بل الحقيقة. وحين تحتجز الحقيقة، يبدأ الإنسان يسمع نفسه ولا يسمعه أحد.”
ثم أضاف وهو يحدّق في الفراغ:
“صوتك محتجز في المكان الذي اختفت منه فوز.”
شعر مراد بأن الكلمات سقطت عليه كحجر.
فوز؟
أين هي؟
ولماذا اختفت؟
وكيف يرتبط صوتُ رجلٍ يبحث عن خلاصه بامرأةٍ كانت مجرد حلم عابر؟
لكن الشيخ لم يمنحه وقتًا لطرح الأسئلة. نهض ببطءٍ وقال:
“اتبعني.”
قاد الشيخ مراد عبر ممرٍ ضيق خلف الدار، ممرّ لم يكن مراد يعلم بوجوده. كانت الجدران تغطيها نقوش قديمة، بعضها كلمات عربية مطموسة، وبعضها رسومات لأيدٍ مقيّدة كأنها تنبض بالألم. توقّف الشيخ أمام باب صغير وقال:
“ادخل وحدك. ما ستراه ليس للعوام.”
فتح مراد الباب ليدخل إلى غرفة معتمة، تتدلّى من سقفها سلاسل خفيفة تصدر طنينًا خافتًا. وفي وسط الغرفة، كانت هناك طاولة خشبية قديمة فوقها صندوق أسود صغير. اقترب منه وهو يشعر بشيء يثقل صدره.
فتح الصندوق.
لم يجد بداخله شيئًا… إلا ورقة أخرى.
كانت الورقة تحمل خطًا يعرفه جيدًا: خط فوز.
كان مكتوبًا فيها:
“إن استطعت الوصول إلى هذه الغرفة… فأنت مستعد لسماع ما لم تُقلْه السنين.”
تجمد مراد. كانت فوز إذن تعرف السر. تعرف صوته، تعرف سجنه الداخلي، تعرف أنه يبحث عنها. ترددت الأسئلة في رأسه، لكن الظلال في الغرفة بدأت تتحرك فجأة، وانطفأت كل الأصوات إلا واحدًا: صوت يشبه شهقة بعيدة، كأن الهواء نفسه فوجئ بوجوده.
ومع ذلك، لم يشعر بالخوف؛ بل شعر بأن ما يحدث هو امتداد طبيعي للحياة التي كان يعيشها، حياة لا حياة بها ولكن بقيّة جذوةٍ وحطام عمر. أدرك في تلك اللحظة أن عليه أن يلاحق هذا الخيط حتى نهايته، مهما تداخلت الظلال وتكاثفت الرهبة.
خرج من الغرفة ليجد الشيخ ينتظره، وقال له:
“الرحلة تبدأ من حيث ينتهي الظلام… وفوز ليست بعيدة كما تظن. لكنها لن تظهر لك حتى تواجه الصوت المحتجز.”
لم يفهم مراد تمامًا، لكنه لم يشأ التراجع. سار من الحي القديم باتجاه النهر، حيث كانت المدينة تصحو ببطء، وحيث يختلط الضوء مع بقايا العتمة. كان النهر يشبه مرآةً واسعة تعكس كل ما في الداخل أكثر مما تعكس ما في الخارج.
عند ضفة النهر، رأى امرأة تقف في مواجهة التيار.
كان شعرها يتحرك مع الريح، وكتفاها يرتجفان قليلاً، كأنهما يحملان سنوات من الانتظار. اقترب منها، وعندما استدارت، عرف أنها فوز، لكنها لم تكن كما كان يتذكرها: كانت أعمق، أكثر هدوءًا، كأنها مرت بسجون صامتة كالتي مرّ بها.
قالت له:
“مراد… كنت أعرف أنك ستأتي. لأنك الوحيد الذي يسمع الصدى.”
لم يتكلم. لم يجد الكلمات. كساكب قطرةٍ في لجّ بحر، ذاب صمته في الهواء.
واصلت هي وهي تحدّق في الماء:
“كنت محتجزة… ليس خلف القضبان، ولكن خلف جدارٍ صنعه الخوف. هناك من أراد لصوتي أن يختفي، كما أراد لصوتك أن يذوب. لكن الأصوات التي تُحب… لا تُقتل.”
ثم مدّت يدها إليه.
ومراد مدّ يده وهو يدرك أنّ تلك اللحظة ليست مجرد لقاء، بل هي تحوّل، كأن الأيام التي تساقطت من حياته كأوراق ذوت تعود لتنبت جذورًا جديدة.
لكن الظلال لم تكن لترحل بسهولة.
فبمجرد أن لامست يده يدها، تغير لون الماء، واهتزّت الضفة، وخرج من بين الأشجار رجل غريب الملامح، كأنه قادم من زمن آخر. كان اسمه ذو العويل، الرجل الذي عاش على صدى أصوات الآخرين، فيحتجزها ليطيل عمره. كان هو من سرق صوت مراد… وصوت فوز.
صرخ ذو العويل:
“لن تهربا… الصوت قوتي.”
لكن مراد لم يعد خائفًا. أمسك بيد فوز بقوة، وشعر بأن ما يسري في جنبيه ليس مجرد روح، بل إنسان كامل يستيقظ، وحبّ الناس فيه يسري.
رفع رأسه وقال بصوتٍ لم يسمعه منذ سنوات:
“صوتي ليس لك.”
وهنا حدث ما يشبه الانفجار الصامت؛ كأن شيئًا تحرر من أعماقه. سقط ذو العويل أرضًا، وانطفأ الظلّ الذي يحيط به، كأن الروح التي كان يتغذى عليها ارتدت إليه. عندها فهم مراد أن الصوت لم يكن يومًا مجرد كلمات… بل كان حياته كلها.
عادت السكينة إلى المكان، وهدأت أمواج النهر، ووقفت فوز قربه مبتسمة، وتلاشت الوحشة التي أحاطت بالعالم من حوله. قال لها بصوت ثابت:
“الآن فقط أعرف معنى النجاة.”
ابتسمت، وقالت:
“والنجاة اسم… وامرأة… ومسار.”
وهكذا، في صباح ذلك اليوم، شعر مراد أن ليله الطويل قد انتهى، وأن الأجيال التي كان يسمع في حنقٍ صدى هول أمره، ستسمع شيئًا مختلفًا: صوت رجلٍ عاد من وراء قضبان لم تُصنع من حديد، بل من خوف.
وبعد شهور قليلة، وقف مراد وفوز تحت شجرة كبيرة قرب النهر الذي شهد عودتهما، وتزوجا في حفل بسيط يجمع الأحبة. كان الشيخ نجاة حاضرًا، يبتسم دون أن يتكلم، كأنه يعرف أن القصص الكبيرة لا تنتهي… بل تتحول.
ومضت حياتهما كدوحٍ تطامن ثم نهض، كزهرٍ ذبل ثم عاد، وكصوتٍ ذاب ثم عاد يعلو في الأفق، لا لينادي العالم، بل ليهمس للمحبّة أنها كانت دائمًا الطريق الوحيد للخلاص.
وفي تلك اللحظة الأخيرة كان مراد يسمع خفقات صدره لا كصدى من وراء القضبان… بل كأغنية حياة جديدة.