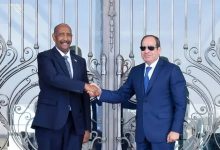في يوم الغذاء العالمي – 16 أكتوبر: آن الأوان لإحياء البحوث الزراعية
بقلم : د. عبد العظيم ميرغني

في يوم الغذاء العالمي – 16 أكتوبر: آن الأوان لإحياء البحوث الزراعية
• في عام 2010، وأمام المدخل الرئيسي لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) في روما، نُصبت خمس لوحات ضخمة باللغات الخمس المعتمدة لدى الأمم المتحدة، تحمل عبارة: “مليار إنسان يعانون الجوع المزمن، وأنا غاضب لذلك جداً… وقع على العريضة للضغط على الساسة ومتخذي القرار لأجل القضاء على الجوع.
• وفي قاعة الهند بمقر المنظمة، حيث كنت مدعواً للمشاركة في ندوة حول دور الغابات في مكافحة الفقر واستئصال الجوع، لفتت نظري صورة للمهاتما غاندي كتب تحتها بخطه: “إلى الملايين الذين يُجبرون على العيش دون وجبتي طعام في اليوم، لا يمكن أن يتجلى الله لهم إلا في هيئة خبز.”
• كانت تلك العبارة صرخة في وجه اللامبالاة، تُلخص مأساة الجوع الإنساني، وهي المأساة التي ما تزال قائمة رغم وفرة الموارد وتقدم العلم.
• لقد أثبت التاريخ أن البحث العلمي الزراعي كان ولا يزال السلاح الأقوى في معركة القضاء على الجوع.
• ففي ستينيات القرن الماضي، أحدثت الثورة الزراعية الخضراء تحولًا عالميًا؛ إذ تضاعف إنتاج الغذاء من المساحة نفسها، فارتفع إنتاج الحبوب من 692 مليون طن عام 1950 إلى نحو 1.9 مليار طن في التسعينات، دون الحاجة لتوسيع الرقعة الزراعية أو تدمير الغابات.
• وفي الهند، التي كانت يوماً تضربها المجاعات، حيث عاش الملايين على وجبةٍ واحدة في اليوم، وبلغت المأساة ذروتها في مجاعة عام 1943 التي حصدت أرواح أربعة ملايين إنسان، أدركت الأمة أن خلاصها لن يأتي بالمساعدات، بل بالعلم والمعرفة.
• ومن هناك بدأت إعادة ترتيب بيتها الداخلي، فأعادت في الستينات والسبعينات تنظيم المجلس الهندي للبحوث الزراعية، الذي كان قد أنشأه المستعمر البريطاني عام 1929، ولم يكن يُعرف له قبل ذلك إنجازٌ بحثي يُذكر.
• فأحدثت بذلك ثورةً ببحثيةً غيَّرت وجه الزراعة.
• فارتفع إنتاج الحبوب من 12 مليون طن عام 1965 إلى 131 مليون طن عام 1979، لتتحول الهند من رمزٍ للجوع إلى واحدةٍ من أكبر منتجي الغذاء في العالم ومصدريه.
• واليوم، يقف العالم على أعتاب ثورة زراعية جديدة، قوامها التقنيات الحيوية والهندسة الوراثية. وقد سارعت دول نامية عديدة إلى دخول هذا المضمار، مستثمرة البحث العلمي لتعزيز مكانتها الاقتصادية والسياسية.
• وكما فعلت الهند في منتصف القرن العشرين، فعلت البرازيل في مطلع القرن الحادي والعشرين، حين جعلت البحث العلمي الزراعي محور نهضتها الحديثة. فحققت إنجازات باهرة في مجالات التقنية الحيوية، بإعدادها الخرائط الوراثية لسلعها الأساسية، فتحت أمام البحوث العلمية آفاقاً مذهلة.
• فشركات صناعة الورق نجحت في رفع إنتاجية أشجار الكافور إلى عشرين ضعف المتوسط العالمي.
• كما نجد الباحثون في فك الشفرة الوراثية لشجرة البن، مما أتاح لصغار المزارعين مضاعفة إنتاجهم وخفض التكاليف إلى النصف، مع تقليل استخدام الكيماويات ومخاطرها البيئية.
• أما السودان، فمدعوٌّ لأن يضع البحوث الزراعية في صدارة أولوياته، صونًا لسيادته وأمنه الغذائي.
• لقد شكل تاريخ البحوث الزراعية في السودان قرنًا من التحول من الزراعة التقليدية إلى الزراعة العلمية، قاده باحثون وطنيون جعلوا المختبر والمزرعة شريكين في خدمة الأمن الغذائي.
• ولكن رغم هذا الإرث العلمي الثري، تعاني منظومة البحوث الزراعية السودانية من ضعف التمويل المزمن وغياب التخطيط والرؤية؛ فلا توجد سياسة وطنية متماسكة تحدد أولويات البحث أو تربط بين مخرجاته وخطط الأمن الغذائي والتنمية الريفية.
• ففي الدول التي تقدمت بالبحث العلمي، أصبحت نتائجه جزءاً أصيلاً من عملية صنع القرار، إذ تُترجم إلى سياساتٍ عامة عبر مجالس علمية وطنية ومراكز تفكير وشراكات فاعلة بين الجامعات والوزارات، مما يجعل القرار قائماً على الأدلة والمعرفة لا على الاجتهاد وحده.
• وفي حين تسابقت الأمم لتسخير البحث العلمي في خدمة الإنسان، ظل السودان، رغم إرثه العلمي العريق، متعثراً في ربط البحث بالتنمية. فضعف التنسيق المؤسسي والتمويل جعلا البحوث بعيدة عن دائرة القرار والتأثير المجتمعي.
• ولعل استعادة البحوث لدورها الفاعل يقتضي فهم طبيعتها كنظامٍ مترابط، لا كجهودٍ متفرقة؛ إذ إن تطور البحوث لا يقوم على نوعٍ واحدٍ من البحث، بل على منظومة متكاملة تتكامل فيها البحوث الأساسية، والتطبيقية، والتحويلية، والاستراتيجية.
• فـالبحوث الأساسية تمثل الجذور التي تمد العلم بفهمٍ أعمق للعمليات الحيوية والطبيعية التي تقوم عليها الزراعة، مثل العلاقات بين النبات والتربة أو تأثير التغيرات المناخية الدقيقة.
• ومن هذه الجذور تنبثق البحوث التطبيقية، التي تحوّل المعرفة إلى حلول واقعية تخدم المزارعين، كاستنباط أصناف مقاومة للجفاف أو تطوير أنظمة ري أكثر كفاءة.
• أما البحوث التحويلية فتعمل على تكييف التقانات العالمية لتناسب البيئات المحلية، فتربط بين المختبر والحقول لتجعل النتائج قابلة للتطبيق في ظروف الإنتاج السودانية.
• وأخيرًا تأتي البحوث الاستراتيجية، التي تضع الرؤية بعيدة المدى وتربط الجهد البحثي بالأمن الغذائي والسيادة الوطنية، مستشرفة مستقبل المياه والطاقة والغذاء في ظل التغير المناخي.
• في هذا اليوم العالمي للغذاء، 16 أكتوبر، ونحن نستعيد كلمات غاندي عن الجوع وكرامة الإنسان، ونستمع إلى مناشدة المنظمة الأممية التي تحتفل بذكرى تأسيسها الثمانين، يجدر بنا أن نحول الغضب إلى فعلٍ إيجابي: دعم البحث العلمي الزراعي بوصفه الضمان الحقيقي للخبز، والكرامة، والسيادة الوطنية.
• وأخيراً، أهناك من لا يدرك قيمة البحث العلمي، حتى نُتعب أنفسنا في التذكير به؟فالعلم الذي لا يجد طريقه إلى الحقل، يظل خبزًا مؤجلًا على موائد الجياع.
آمالي في حسن الخلاص؛ وتحياتي.