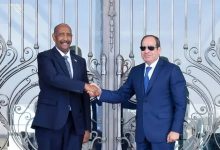الرواية العربية بين ألف ليلة وليلة والمستقبل العالمي: من الخيال إلى الاستراتيجية
بقلم : د. محمد صلاح علي الفكي

الرواية العربية بين ألف ليلة وليلة والمستقبل العالمي: من الخيال إلى الاستراتيجية
تُعد الرواية العربية من أبرز الإبداعات الإنسانية التي حفظت الذاكرة الجماعية للأمة، ونقلت تفاصيل تطورها الفكري والاجتماعي والاقتصادي والسياسي على مر العصور. فمنذ أن خرجت «ألف ليلة وليلة» من عباءة السرد الشعبي إلى فضاء الأدب العالمي، أصبح للعرب بصمة فكرية وثقافية عالمية لا يمكن تجاهلها. لم تكن تلك الحكايات التي جمعت بين الحكمة والمتعة والخيال والواقع مجرد تسلية لليالي الشرق، بل كانت مشروعًا مبكرًا لبناء الوعي الإنساني، وصياغة قيم العدالة والمعرفة والتسامح في قالب قصصي يعكس نضج العقل العربي وقدرته على صناعة المعنى.
إن «ألف ليلة وليلة» لم تكن مجرد حكاية تُروى، بل كانت فلسفة للحياة، ومختبرًا للقيم، ومنصة للتفكير في السلطة والمعرفة والحرية والمرأة والمجتمع. ومن خلالها أدرك العالم أن الخيال العربي قادر على أن يكون مصدرًا للفكر الكوني، وأن السرد العربي لا يقل عمقًا عن الفلسفة ولا عن علم الاجتماع. فالرواية منذ نشأتها الأولى كانت ولا تزال وسيلة الإنسان العربي لفهم ذاته ومجتمعه والعالم من حوله.
ومع تطور الزمن، تحولت الرواية من فن السرد التقليدي إلى أداة استراتيجية لبناء الوعي والإصلاح الاجتماعي. فهي ليست نصًا أدبيًا فحسب، بل وثيقة اجتماعية واقتصادية تعكس نبض الأمة، وتحلل طبيعة العلاقات داخل المجتمع، وتطرح الأسئلة الكبرى حول العدالة والتنمية والكرامة الإنسانية. لقد أصبحت الرواية اليوم مرآة للمجتمع في تحوّله من الريف إلى المدينة، ومن القهر إلى الحرية، ومن الفوضى إلى الحوكمة.
ولأن الأدب هو صورة المجتمع، فإن العلاقة بين الرواية والشعر في التراث العربي تمثل وحدة عضوية في بنية الوعي الثقافي. فالشعر كان ديوان العرب في الجاهلية، والرواية صارت ديوان واقعهم الحديث. امتزجت فيها الحكمة بالشعور، والعقل بالوجدان، والفكر بالحياة اليومية، فأصبحت أكثر من فن جمالي؛ إنها أداة تحليل اجتماعي وتخطيط ثقافي بامتياز.
لقد برز في العالم العربي روائيون كبار حملوا مشاعل هذا الفكر الإبداعي، منهم نجيب محفوظ، الطيب صالح، عبد الرحمن منيف، غسان كنفاني، أحلام مستغانمي، وإبراهيم الكوني، وغيرهم من الذين جعلوا من الرواية وسيلة لتفكيك الواقع وإعادة بنائه. نجيب محفوظ مثلاً لم يكن يكتب عن الحارة فحسب، بل عن المجتمع المصري والعربي بكل تناقضاته، وكان في فكره يُخطط لمستقبل الإنسان من خلال قراءة الماضي. أما الطيب صالح فحوّل «موسم الهجرة إلى الشمال» إلى نص حضاري يربط بين صدمة الحداثة والهوية.
وفي عصر العولمة، تجاوزت الرواية العربية حدودها الجغرافية، لتصبح صناعة فكر واقتصاد معرفة. فالرواية اليوم لم تعد فقط مشروعًا ثقافيًا بل صناعة استراتيجية تسهم في الناتج القومي الثقافي، وتخلق فرص عمل في مجالات النشر والترجمة والسينما والمسرح والمنصات الرقمية. ومن هنا تنشأ الحاجة إلى أن تكون إدارة الدراسات الاستراتيجية والتنموية شريكًا رئيسيًا في إدماج الأدب ضمن خطط التنمية المستدامة.
فالرواية يمكن أن تكون أداة للتخطيط الناعم، لأنها تُعيد تشكيل وعي الإنسان، والوعي هو الخطوة الأولى في أي نهضة حقيقية. وكما تبني الدول استراتيجياتها على الاقتصاد والبنية التحتية، يجب أن تبنيها أيضًا على الثقافة والمعرفة والخيال. فالثقافة استثمار طويل المدى في الإنسان، والإنسان هو رأس المال الاستراتيجي الأول لأي دولة.
الرواية إذن ليست انعكاسًا للواقع فقط، بل وسيلة لتغييره. إنها القوة الناعمة التي تُكمل القوة الصلبة، والدبلوماسية الهادئة التي تُعبّر عن القيم المشتركة بين الشعوب. ومن هنا يمكن القول إن كل رواية عربية هي وثيقة دبلوماسية وثقافية في آن واحد، تسهم في بناء صورة إيجابية للعرب في الوعي العالمي، وتُظهر أن الحضارة العربية قادرة على الإبداع والتجدد.
ولأن بناء الإنسان لا يتم إلا عبر مشروع ثقافي متكامل، فإن الحاجة اليوم ملحّة إلى دمج الأدب والرواية ضمن رؤية استراتيجية شاملة لبناء الوعي الوطني والعالمي. فالأمم المتقدمة لم تنهض بالمال وحده، بل بالثقافة والمعرفة والتخطيط، ومن هنا تأتي أهمية تحويل الإنتاج الأدبي إلى قيمة اقتصادية وفكرية معًا.
التوصيات
1. إدماج الرواية ضمن الاستراتيجية الثقافية الوطنية بوصفها جزءًا من الأمن الثقافي والهوية، وذلك من خلال دعم صناعة النشر، وتنظيم الجوائز الوطنية للرواية، وتوسيع مبادرات القراءة العامة في المدارس والجامعات.
2. تحويل الإبداع الأدبي إلى اقتصاد معرفي عبر الاستثمار في الصناعات الثقافية والإبداعية (Creative Industries)، مثل تحويل الروايات إلى أعمال درامية وسينمائية وألعاب رقمية، مما يعزز النمو الاقتصادي ويوفر فرص عمل جديدة للشباب.
3. إنشاء مراكز دراسات وتحليل أدبي واستراتيجي تُعنى بقراءة التحولات الفكرية والاجتماعية من خلال الأدب، بحيث تسهم نتائجها في صياغة السياسات العامة، تمامًا كما تفعل مراكز التحليل الاقتصادي والسياسي.
4. تفعيل الدبلوماسية الثقافية العربية بترجمة الروايات المتميزة إلى اللغات العالمية، وتنظيم معارض ومنتديات دولية للأدب العربي، بما يعزز الحضور الثقافي العربي في المحافل العالمية، ويجعل الرواية أداة لتقوية العلاقات بين الشعوب.
5. إدخال الأدب في برامج التدريب القيادي والإداري، لما تحمله الرواية من دروس في علم النفس والسلوك التنظيمي واتخاذ القرار، مما يساعد في بناء قيادات مؤسساتية تجمع بين الحكمة والخيال والإنسانية.
6. تعزيز الإطار القانوني والإداري لصناعة النشر عبر تحديث تشريعات الملكية الفكرية وضمان حقوق المؤلفين والناشرين والمترجمين، بما يرسخ العدالة الثقافية ويضمن الاستدامة في الإنتاج الأدبي.
7. إطلاق رؤية عربية موحدة للثقافة والإبداع في إطار منظمة عربية للصناعات الثقافية والإبداعية، لتوحيد الجهود وبناء مشروع ثقافي استراتيجي يعيد للأمة دورها الحضاري الريادي.
مكتبة كتارا للرواية العربية: نموذج للوعي الثقافي المؤسسي
تأتي مكتبة كتارا للرواية العربية بوصفها نموذجًا عمليًا لتجسيد الوعي المؤسسي بالثقافة كقوة استراتيجية للأمم. فهي لا تكتفي بجمع الروايات، بل تعمل على توثيقها وتحليلها وتقديمها للعالم في إطار حديث من الحوكمة الثقافية والمعرفة المفتوحة. تمثل كتارا اليوم جسرًا بين الماضي والحاضر، بين التراث السردي العربي وبين العالمية الرقمية المعاصرة، وتعيد للرواية مكانتها كوسيلة للتنمية الإنسانية، وتعزيز الهوية الثقافية العربية في بعدها الإنساني العالمي.
من خلال مبادراتها وجوائزها وبرامجها البحثية، تؤكد كتارا أن الثقافة ليست هامشًا بل عنصرًا من عناصر الأمن القومي والتنمية المستدامة. إنها تمثل الرؤية التطبيقية لما يجب أن تكون عليه مؤسسات الثقافة العربية: مؤسسات توازن بين الأصالة والمعاصرة، وتخدم الإنسان قبل النص، والمجتمع قبل الشهرة.
إن الرواية العربية، منذ “ألف ليلة وليلة” وحتى أحدث الإصدارات الرقمية، ليست مجرد حكاية تُروى، بل مشروع وطني وإنساني واستراتيجي متكامل لبناء الوعي والإنسان. فهي الاقتصاد الناعم الذي يثري الفكر قبل المال، والدبلوماسية التي تُعيد الثقة بين الشعوب، والذاكرة التي تحفظ الأمة من الضياع.
وفي زمن تتسارع فيه التحولات، تظل الرواية العربية وعدًا بالاستمرار في الحلم، وشهادة على أن الخيال العربي ليس هروبًا من الواقع، بل طريقًا لإصلاحه وصناعته من جديد.