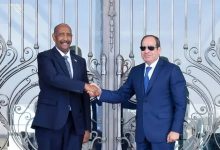الغباء
يُعدّ الغباء واحدًا من أكثر الظواهر الإنسانية ثباتًا وانتشارًا، لا لأنه نقص في الذكاء فحسب، بل لأنه خلل مركّب في الإدراك والوعي بالذات. وقد عبّرت الحكمة القديمة عن ذلك بدقة حين صنّفت البشر وفق علاقتهم بالمعرفة والوعي بها:
رجل يدري ويدري أنه يدري، فذلك عالم فاتبعوه.
ورجل يدري ولا يدري أنه يدري، فذلك نائم فأيقظوه.
ورجل لا يدري ويدري أنه لا يدري، فذلك مسترشد فأرشدوه.
ورجل لا يدري ولا يدري أنه لا يدري، فذلك جاهل فأعرضوا عنه.
هذا التصنيف لا يتوقف عند حدود العلم، بل يمسّ جوهر السلوك الإنساني، ويكشف الفارق الحاسم بين الجهل القابل للعلاج، والغباء المستعصي على التصحيح. ومن هنا تبرز دلالة مصطلح الإندِراية؛ وهي كلمة مدمجة من مقطعين: (In) من الإنجليزية بمعنى النفي أو الدخول في حالة، و(دراية) من العربية بمعنى المعرفة، وقد قُلبت الياء واوًا لتستقيم القافية والدلالة. والمقصود بها حالة عدم المعرفة المصحوبة بغياب الوعي بهذا العدم، وهي أخطر من الجهل البسيط، لأن صاحبها يظن أنه يعلم، فيغلق باب التعلّم ويقاوم التصحيح.
في هذا السياق، قدّم المفكر الاقتصادي الإيطالي كارلو شيبولا، في كتابه الشهير «قوانين الغباء البشري»، تحليلًا بالغ العمق حين قسّم البشر – من زاوية الأثر لا النية – إلى أربعة أصناف: العاقل الذي يحقق منفعة لنفسه وللآخرين، والمغفّل الذي يخسر لصالح غيره، والشرير الذي يربح على حساب الآخرين، والغبـي الذي يسبب خسائر للآخرين دون أن يحقق لنفسه منفعة، وقد يخسر معهم. وتكمن خطورة الغبي في أن سلوكه غير قابل للتنبؤ، وأن أثره التخريبي لا يرتبط بمصلحة أو هدف واضح، ما يجعله أكثر الأصناف تدميرًا على المدى الطويل.
وتؤكد الأدبيات الحديثة أن نسبة الغباء ثابتة نسبيًا في أي مجتمع، بغضّ النظر عن مستوى التعليم أو التقدم التقني. فالغباء لا يعترف بالطبقات ولا بالمهن؛ فقد يكون الطبيب غبيًا في قراره، والكاتب غبيًا في تحليله، والمسؤول غبيًا في إدارته، بل وقد يصل الغبي – في ظل هشاشة المؤسسية وتآكل المعايير – إلى أعلى مواقع السلطة، ويصير رئيسًا أو قائدًا، لا لذكائه، بل لغياب أنظمة الفرز والضبط والتوازن.
وقد أدرك تراثنا العربي هذه الحقيقة مبكرًا، فامتلأت المكتبة العربية بكتبٍ خصصت لرصد الغباء والحمق، لا للسخرية فقط، بل للعبرة والتحذير. من ذلك «أخبار الحمقى والمغفلين» لابن الجوزي، و**«البخلاء» و«البيان والتبيين» للجاحظ**، و**«العقد الفريد» لابن عبد ربه**، و**«عيون الأخبار» لابن قتيبة**. واللافت في هذه المؤلفات أن أصحابها نادرًا ما ركّزوا على تسمية الأشخاص، بل اكتفوا بسرد الموقف الغبي ونتيجته، لأن العبرة في الفعل لا في الفاعل. فقد يُهلك قرار واحد غير محسوب مالًا عامًا، أو يُضيّع فرصة، أو يُفسد أمر جماعة كاملة، دون حاجة إلى توصيف أو تشهير. وهذا المنهج التراثي يكشف وعيًا مبكرًا بأن الغباء يُدان بآثاره لا بأسمائه.
ومن منظور علم النفس المعرفي، يُفسَّر الغباء العملي بما يُعرف بانحياز الثقة الزائدة وتأثير دانينغ–كروغر، حيث يبالغ محدودو الكفاءة في تقدير قدراتهم، بينما يشكّ الأكفّاء في أنفسهم. أما في الإدارة والاقتصاد والاجتماع، فيظهر الغباء حين تُتخذ قرارات كبرى بلا بيانات، ويُصرّ أصحابها على صوابها رغم فشل النتائج، أو حين تُكافأ الطاعة ويُعاقَب التفكير، ثم يُستغرب تراجع الأداء وانهيار الثقة.
وتكمن إحدى أخطر مشكلات الغباء في صعوبة اكتشافه مبكرًا؛ فهو لا يظهر دائمًا في صورة فجة أو تصرّف طائش، بل كثيرًا ما يتخفّى خلف لغة منمّقة، أو موقع رسمي، أو خطاب أخلاقي حاد، أو ثقة عالية بالنفس. وقد ينجح الغبي – بخلاف الجاهل – في إقناع محيطه لفترة، لأن يقينه المرتفع يمنحه حضورًا زائفًا، بينما يتردد العاقل في الجزم. وهنا يتحقق أخطر توازن مقلق: ثقة عالية مع كفاءة منخفضة.
وتبرز أوجه القصور الكبرى في التعامل مع الغباء في الخلط بين الاحترام والسكوت، وتقديس الموقع لا الكفاءة، وتأجيل التصحيح حتى تتراكم الخسائر. وعند هذه النقطة يتحول الغباء الفردي إلى كارثة جماعية، لأن البيئة المؤسسية الهشة تسمح له بالتمدد، وتمنحه حصانة غير مستحقة. فالغباء لا يصبح خطرًا إلا حين يجد نظامًا لا يصحّح نفسه، ونخبًا تفضّل السلامة على المواجهة، والمجاملة على الصدق.
ومن هنا، يصبح السؤال العملي ليس: هل يمكن القضاء على الغباء؟ فذلك مستحيل، بل: كيف نُدير أثره؟ إذ إن التفاهم ممكن مع الجاهل الواعي بجهله، ومع النائم الذي يحتاج إيقاظًا، ومع العالم الذي يُنصت للحجّة، لكنه بالغ الصعوبة مع الغبي أو الإندرايي، لأن الحوار يفترض حدًّا أدنى من الاعتراف بإمكانية الخطأ. لذلك توصي الأدبيات الحديثة بإدارة الأثر بدل استنزاف الجهد في إقناعٍ عقيم، أي تقليص مساحة الضرر بدل مطاردة الوهم.
نماذج تراثية متسلسلة لقرار غبي في السياق المؤسسي
وعلى هذا الأساس، لم يكن التراث العربي غافلًا عن رصد الغباء بوصفه سلوكًا له أثر عام، يتجاوز الفرد إلى الجماعة، ويتحوّل – إذا اقترن بالسلطة أو القرار – إلى خطرٍ مؤسسي. فقد روى أهل الأخبار عن رجل ضاق منزله، فقيل له: وسّع بابه، فهدم الجدار كله، ثم بقي يشكو ضيق المكان. والعبرة هنا ليست في قلة الفهم، بل في اتخاذ قرار جذري بلا تصور للأثر، وهو ما يعادل مؤسسيًا إلغاء نظام كامل لمعالجة خلل جزئي. ورووا عن آخر خشي احتراق بيته من السراج، فأطفأه، فعثر في الظلام وانكسرت رجله، ثم حمد الله على سلامة البيت، في صورة مبكرة لتبرير الخسارة الواقعة بذريعة نية الوقاية، كما يحدث حين تُدمَّر المنافع باسم الحماية. وذكروا أن رجلًا وُكِّل بحراسة متاع، فجاءه من أقنعه بالكلام حتى سلّمه المتاع ليحمله عنه، فانصرف به، وهو نموذج للقرار الذي يُتخذ بثقة لغوية لا بكفاءة، فيُسلَّم الأصل لمن لا يستحق بحسن ظنّ لا بضبط. وحُكي عن طبيب أصرّ على علاج واحد رغم ظهور فشله، حتى هلك المريض، فقال: لو صبر لبرئ، وهو ما يماثل الإصرار المؤسسي على سياسة فاشلة مع تعليق الخطأ على الزمن لا على القرار. ورووا عن والٍ أمر ببناء سور للمدينة من جهة واحدة، بحجة أن العدو لا يأتي إلا منها، فلما أُتي من الجهة الأخرى قال: ما خطر لي ذلك، وهو نموذج للقرار العام المبني على تصور جزئي يُقدَّم بوصفه رؤية شاملة. كما ذُكر أن رجلًا سُئل عن بئر سقطت فيها دابة، فأمر بسدّها كلها حتى لا يسقط غيرها، فضاع الماء على أهل القرية، في مثال صريح لإزالة الأصل لمعالجة الاستثناء. ورووا عن رجل كسر الميزان لأنه لم يعجبه وزنه، فاستراح، في صورة رمزية لتدمير أدوات القياس بدل مراجعة السلوك أو الأداء.
والجامع بين هذه الأخبار، أن الغباء لم يكن في الجهل وحده، بل في غياب الوعي بالأثر، وفي اليقين غير القابل للمراجعة، وفي القرار الذي يُتخذ بثقة أعلى من كفاءته. وهي ذات السمات التي يظهر بها القرار الغبي حين ينتقل من فرد محدود الأثر إلى موقع عام واسع التأثير، فيتحول من حكاية تُروى إلى كلفة تُدفَع.
توصيات:
1 .التمييز المؤسسي الصارم بين الجهل القابل للتعلّم والغباء المستعصي على التصحيح، وعدم مساواتهما في مواقع القرار.
2. ربط صناعة القرار بالبيانات والتحقق والتقييم المستقل، لا بالثقة الشخصية أو الصوت الأعلى.
3 .إنشاء آليات مراجعة دورية ومستقلة للسياسات والقرارات لاكتشاف الخطأ مبكرًا قبل تضخّم كلفته.
4. حماية مواقع التأثير العام بمعايير كفاءة واضحة وشفافة لا تتغير بتغيّر الأشخاص أو المزاج.
5. تقليص القرار الفردي غير الموثق، وتوسيع دوائر التشاور المهني الحقيقي لا الشكلي.
6. ترسيخ ثقافة الاعتراف بالخطأ بوصفها قوة تنظيمية، ومكافأة من يصحّح المسار بدل معاقبته.
7. إدارة الغباء بتقليل أثره عبر ضبط الصلاحيات وربطها بالنتائج، لا بمحاولة إقناع صاحبه مباشرة.
8.الاستثمار في تعليم نقدي يعلّم كيف نفكّر، لا ماذا نحفظ، ويكسر وهم المعرفة الزائفة.
ليس الخطر في الجهل، فالجهل يُداوى بالعلم، بل في الغباء الذي يُغلق باب التعلّم ويُلبس الخطأ ثوب اليقين. والمجتمعات التي تنجح ليست تلك التي تخلو من الأغبياء، فذلك وهم، بل التي تبني نظمًا تقلّل أثرهم، وتمنع صعودهم غير المستحق، وتُعلي من شأن العقلانية والمؤسسية. فعندما يُدار الإنسان بوعيٍ بحدوده، وتُدار الدولة بأنظمة تصحّح ذاتها، يتحول الغباء من قوة مدمّرة إلى ظاهرة مُدارة، وتتحول المعرفة من شعار إلى أثر، ومن فكرة إلى قوة بناء حقيقية.
ومن هنا تتبدّى أهمية إدارة الغباء لا بوهم استئصاله، بل بالتعرّف المبكر على أنماطه، وضبط أثره المؤسسي، وربط القرار بالبيانات والمساءلة لا بالأشخاص. فالمجتمعات التي تنجح هي التي تبني نظمًا تكشف الخطأ سريعًا، وتحدّ من تمدده، وتمنع تحوّله إلى مسار عام. ومتى أُغلِقَت منافذ القرار أمام اليقين غير القابل للمراجعة، تقلّص خطر الغباء مهما تعذّر إلغاؤه.
ومفارقة الغباء أنه لا يكتفي بإغلاق باب التعلّم، بل يرفض أصل التشخيص؛ فالغبيّ – وإن شُهِد عليه بآثاره – لا يقبل أن يُقال له غبي، لأن إنكار العيب شرطٌ لبقائه، لا عارضٌ من عوارضه.