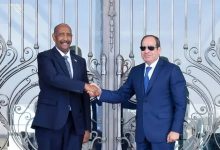المجلس الأعلى للبيئة: من الدكتور محمد عبد الله إلى الدكتورة منى
• استضعفوك، فوصفوك… فهلا وصفوا شبل الأسد؟”
• روى أن أبا العلاء المعري حين اشتد عليه المرض، وصف له الأطباء الدجاج، فذُبح ونتُف ريشه وأُتي به مشوياً.
• وحين رآه قال عبارته الشهيرة هذه، والتي تصلح مدخلاً لتحليل كثير من شؤوننا العامة، حين ننشغل بالأشخاص والأسماء، ونغفل البُنى والأفكار.
• عند تناول أي شأن عام — سياسي، اجتماعي، أو معرفي — يمكن تحليله عبر ثلاثة مستويات متداخلة:
• مستوى الأفكار، وهو الأعمق، حيث تتشكل الرؤى الكبرى والقيم الحاكمة. وقد لا يُحدث هذا المستوى ضجيجاً فورياً، لكنه يغرس البذور التي تتحول لاحقاً إلى سياسات ومؤسسات.
• مستوى الأحداث، وهو الظاهر للعيان، حيث تتحول الأفكار إلى برامج وقرارات وأنشطة، وغالباً ما تُقرأ هذه الأحداث بمعزل عن جذورها الفكرية.
• مستوى الأشخاص، وهو الأكثر جذباً للإعلام، إذ يُختزل النقاش في الأسماء والمناصب، رغم أن الأشخاص -في الغالب- يجسّدون أطرًا مؤسسية قائمة، لا يصنعونها من فراغ.
• وفي هذا الإطار، حين بشّرت حكومة الأمل بقيادة الدكتور كامل إدريس، بسياسة وطنية بيئية مستدامة، وأُعلن عن قيام وزارة للبيئة والاستدامة، بدا الأمر وكأنه انتقال نوعي من المقاربات الموسمية إلى بناء مؤسسي راسخ.
• غير أن هذه الوعود لم تتحقق فعلياً؛ إذ لم تُنشأ الوزارة حتى الآن.
• وسط هذا الفراغ المؤسسي، كثيراً ما يَرِد اسم الدكتورة منى علي محمد أحمد، الأمين العام للمجلس الأعلى للبيئة، بوصفها “وزيرة البيئة.
• هذا الخلط بين الوزارة والمجلس، وبين المنصب والشخص، لا يعكس خطأً بروتوكولياً فحسب، بل يكشف ضبابية أعمق في فهم طبيعة الكيان البيئي القائم في السودان في الوقت الراهن.
• إن قوة المؤسسات لا تُقاس بأسماء شاغليها، بل بوضوح أدوارها وقابلية مساءلتها.
• ولفهم الإشكال على نحو أدق، لا بد من الرجوع إلى التطور التاريخي للمجلس الأعلى للبيئة.
• فمنذ تأسيسه في عام 1991/1992، نشأ كجسم تنسيقي واستشاري بالأساس، وانحصر دوره في توحيد السياسات البيئية، وتعزيز التنسيق بين الوزارات، وبين المركز والولايات، وفي تمثيل السودان في الاتفاقيات البيئية الدولية.
• وكان هيكله بسيطاً ومحدوداً، يقتصر عملياً على منصب الأمين العام، الذي شغله الراحل الدكتور محمد عبد الله.
• ومع مرور السنوات، ومع استمرار المجلس في أداء مهامه التنسيقية التقليدية، بدأ دوره يتوسع تدريجياً ليشمل المشاركة الفعلية في تنفيذ البرامج والمشروعات البيئية.
• وقد انعكس ذلك في توسع هيكله ليضم إدارات ووحدات ذات طابع تنفيذي، فانتقل من مجلس تنسيقي خالص إلى كيان مزدوج الوظيفة: تنسيقي وتنفيذي معاً.
• وبعد دمج مجالس أخرى إليه عام 2020، مثل مجلس السلامة الحيوية ذو الطبيعة التنفيذية الأصيلة، تعزز هذا الدور التنفيذي، ليصبح جزءاً من واقعه العملي، لا من تعريفه القانوني فقط.
• هنا تبرز الإشكالية الجوهرية: في أي مؤسسة فاعلة، تتكامل البنية الهيكلية مع الوظيفة العملية؛ فالتنسيق وظيفة، والتنفيذ وظيفة مختلفة في الأدوات والمساءلة والموارد.
• فعندما يتحول كيان تنسيقي إلى كيان تنسيقي–تنفيذي دون وضوح فلسفي وتشريعي، تختلط الأدوار، ويُحمَّل الأشخاص أكثر مما يحتمل الهيكل نفسه.
• وتُظهر التجارب الدولية أن الدول التي نجحت في إدارة الشأن البيئي، إما أنها فصلت بين المجالس التنسيقية والوزارات التنفيذية، أو أنها رفَّعت الكيان القائم إلى مستوى وزارة كاملة الصلاحيات.
• أما الإبقاء على وضعٍ رمادي يجمع بين الوظيفتين، كالوضع الذي عليه المجلس الأعلى للبيئة حالياً، فلم يُنتج في أي تجربة معروفة وضوحاً مؤسسياً أو مساءلة فعالة.
• السؤال الحقيقي المطروح هنا هو: ما القيمة المضافة التي حققها تحول المجلس من كيان تنسيقي إلى كيان مزدوج الوظيفة؟
• وهل هذا التحول جاء كخيار مؤسسي واعٍ؟
• وهل هو يخدم البيئة؟
• وأرجو ألا يُفهم من هذا الطرح انتقاصٌ من دور المجلس أو من أدائه، فقد سبق أن أشاد مجلس الوزراء الموقر في عام 2022 رسمياً بأدائه وعمله؛ غير أن الإشادة بالأداء والعمل لا تُغني عن مسألة البناء المؤسسي الذي يعمل من خلاله.
• المسألة هنا هي أن الخلل لا يكمن في الأشخاص ولا في نواياهم، بل في غياب الوضوح المؤسسي الذي يحدد بدقة وظيفة المجلس وحدود أدواره، ويقيم علاقة متوازنة بين التنسيق والتنفيذ.
• عند هذه النقطة، يصبح التركيز على الأشخاص مجرد عرض، بينما يبقى جوهر القضية هو طبيعة الكيان نفسه: تنسيقي أم تنسيقي–تنفيذي؟
آمالي في حسن الخلاص؛ وتقديري العميق.