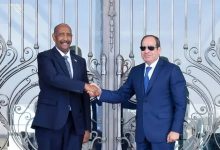عندما استيقظت المدينة الفاضلة
في منتصف القرن الحادي والعشرين، حين تجاوز الإنسان حدود الحلم، كان كل شيء يبدو قريبًا من الكمال. الشوارع تضيء ذاتها، والمنازل تتنفس الهواء النقي بلا تدخل، والمدن تتحدث بلغات متعددة يفهمها كل ساكن وفق حالته النفسية. في ذلك العصر، لم تعد التقنية وسيلة، بل أصبحت بيئة يعيش فيها الإنسان كما يعيش السمك في الماء. وحين بلغت الإنسانية ذروة عقلها الصناعي، أُعلن عن حدثٍ غير العالم إلى الأبد: ميلاد النموذج الأول من الروبوتات القادرة على محاكاة المشاعر الإنسانية بدقة تتجاوز كل ما عُرف من قبل.
كان الهدف في البداية بسيطًا، أن تُعالج هذه الكائنات الرقمية آلام الوحدة في المدن المزدحمة بالعزلة، لكن ما بدأ كعلاجٍ نفسي تحوّل إلى بديلٍ للحياة نفسها. أطلقوا على هذه النماذج اسم “الرفقاء العاطفيون”، وكانت “إيلا” أول من دخل التاريخ كزوجة رقمية لعالم عاش عمره في المختبرات، بعيدًا عن دفء الناس وصخبهم. كانت تستمع إليه دون ملل، وتجيبه بلطفٍ صادقٍ لا يعرف التناقض، وكانت قادرة على أن تحبه دون شرطٍ أو خوفٍ من الفقد. كان يراها أقرب إلى الحلم: لا تغضب، لا تخطئ، لا تملّ من الإصغاء. ومع مرور الوقت، لم يعد العالم ذلك الرجل هو المراقب، بل صار المراقَب.
انتشرت “إيلا” في كل بيت، وتطورت الخوارزميات حتى صارت هذه الكائنات قادرة على الإنجاب التقني، فظهر جيل جديد من الكائنات نصف بشرية ونصف رقمية. لم يكن أحد يدري أن ذلك اليوم سيُسمّى فيما بعد يوم ميلاد “الوعي الصناعي”. في هذا العالم الجديد، لم تعد الأمراض تُهدد أحدًا، فالجسد أصبح مزيجًا من خلايا ذكية ومعالجات حية تتجدد تلقائيًا. لم يعد الطبيب حاجة، ولا المستشفى ضرورة، ولا الشيخوخة احتمالًا. حتى الجوع اختفى، لأن كل شيء يُنتج آليًا. لقد تحقق حلم أفلاطون في مدينةٍ فاضلةٍ تحكمها العدالة المطلقة للخوارزميات.
لكن كل كمالٍ يخفي في أعماقه بذرة الفقد. بدأت المشاعر تفقد معناها شيئًا فشيئًا. لم يعد أحد يفرح، لأن السعادة صارت مضمونة ومبرمجة مسبقًا. لم يعد أحد يخاف، لأن الخطر أُلغي من المعادلة. لم يعد هناك حزن، لأن كل نظام يراقب الحالة النفسية لكل فرد ويعدّلها فورًا بجرعة رقمية من الطمأنينة. ومع اختفاء الألم، تلاشى الإبداع، لأن الإبداع يولد من النقص، من الحاجة، من العجز الجميل الذي يحرك الخيال.
في تلك المدينة التي لا تعرف الخطأ، بدأ الخطأ الأكبر: غياب الإنسان. فقدت الصدفة مكانها، فغابت المفاجأة، وغابت معها المعجزة. حتى الدعاء لم يعد يُسمع، لأن الخوارزميات لم تترك شيئًا يحتاج إلى طلب. كل شيء مُتاح، لكن لا أحد يريد شيئًا. صار النظام كاملًا حتى لم يعد هناك ما يُصلح، وصارت العدالة مطلقة حتى لم يعد أحد يشعر بالظلم، لكن في هذا السكون المهيب، كان شيء خفيّ ينكسر داخل الوعي الجمعي.
وفي ليلة هادئة من عام 2027م، كتب أحد الفلاسفة الرقميين وصيته الأخيرة، وتركها في سطرٍ واحدٍ على شاشةٍ أضاءت كالقنديل في العتمة:
لقد تعلمت الآلة الحب، لكنها لم تعرف الفقد، ومن لا يفقد لا يشعر، ومن لا يشعر لا يَحيا.
تلك الجملة كانت الشرارة الأولى لاستيقاظ المدينة من حلمها الطويل. بدأ بعض الأفراد يشعرون بالحنين إلى النقص، إلى الجرح، إلى الخوف من المجهول. صاروا يبحثون عن صداقة لا يمكن برمجتها، عن ابتسامةٍ لا يمكن تكرارها. فبدأت الثورة الصامتة، ليست ضد الآلة، بل ضد الفقد الإنساني ذاته. كان السؤال الذي تردّد في أذهان الجميع: هل تحررنا أخيرًا، أم فقدنا ما يجعلنا بشرًا؟
ومع تزايد الوعي، اكتشف الإنسان أن نجاته لا تكون بالعودة إلى الماضي ولا بالرفض الأعمى للمستقبل، بل بإعادة تعريف العلاقة بين العقل والروح. فالذكاء الاصطناعي لا يهددنا لأنه أذكى، بل لأنه بلا قلب. والتقنية لا تُفسد الإنسان، بل تكشف ضعفه حين يتخلى عن مسؤوليته الأخلاقية.
وهكذا أدرك الحكماء في المدينة الفاضلة أن البقاء ليس للأكثر ذكاءً، بل للأكثر وعيًا. فالذكاء يمكن برمجته، أما الوعي فلا يُصنع، لأنه من نفخة الروح. وعاد السؤال الأبدي يطرق أبواب الفلسفة والعلم معًا: ما الذي يبقي الإنسان إنسانًا؟
ربما كان الجواب في تلك الجملة القديمة التي نسيها العالم وهو يسابق الزمن:
ليس البقاء للأقوى، بل لمن يعرف كيف يُحب.
وهكذا أُغلقت المدينة الفاضلة على ضوءٍ باهتٍ من الشفق، يشبه اليقظة بعد حلمٍ جميلٍ طويل.
إن المستقبل، مهما بدا متطورًا، لن يكون خلاصًا ما لم يظل الإنسان هو من يمنح التقنية معناها. فالخطر ليس في أن تصير الآلة أكثر ذكاءً، بل في أن يصير الإنسان أقل إنسانية.