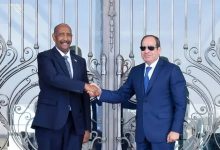تحولات الإدراك والمعيشة لدى اللاجئ السوداني: دراسة في الرضا النسبي والتكيف تحت الضغط
بقلم : د.محمد صلاح علي الفكي

تحولات الإدراك والمعيشة لدى اللاجئ السوداني: دراسة في الرضا النسبي والتكيف تحت الضغط
تحوّل إدراك المواطن السوداني من التذمر إلى الامتنان، ومن اليأس إلى التكيف، ومن طلب الكمال إلى السعي للبقاء. هذه ليست مجرد استجابات ظرفية، بل هي تغيرات عميقة في البنية النفسية والاجتماعية للإنسان تحت الضغط. ولفهم هذه التحولات، علينا أن ننظر إلى الإنسان السوداني، سواء داخل البلاد أو من اضطرته الظروف إلى اللجوء، لا كضحية فقط، بل كفاعل اجتماعي يصوغ واقعاً جديداً بوعي وإرادة. فالحرب لم تغير الجغرافيا فقط، بل أعادت تشكيل نظرة الإنسان إلى الحياة ذاتها، وأعادت ترتيب أولوياته وأسئلته اليومية.
في السودان، وقبل اشتعال الحرب، كانت الحياة تنهك الإنسان. الحصول على الخبز يتطلب بطاقة تموينية وصفوفاً تمتد لساعات. الوقود شحيح، الكهرباء منقطعة، والتعليم في حالة انهيار. كنا نغادر منازلنا للعمل متأخرين بعد صراع يومي مع أساسيات البقاء. وفي أحد تلك الأيام، وقفتُ في طابور طويل لأكثر من ست ساعات في انتظار الخبز، وكان يقف أمامي مواطن مصري، يتعامل مع الانتظار بلا ضيق ظاهر. بينما أنا أُفكّر في تأخري عن عملي وفي الجهد المبذول من أجل حفنة خبز، كان هو يسبّ ويلعن في الحكومة المصرية، فقلت في نفسي: “معليش… لو كان بيكلم شخص من بلد مستقر اقتصادياً زي الخليج، كان ممكن كلامه يُعتبر معقول… لكن يشوف الحال اللي نحن فيه؟”
قلت له في سري: “تعال خذ كل السياسيين الموجودين جوه وبره، وسجّنهم، وهاتوا لينا حكومتكم.”
المفارقة هنا ليست فقط في الفارق بين الواقعين، بل في زاوية الإدراك؛ أنا أعيش ضغطًا حقيقيًا من أجل أساسيات البقاء، بينما هو ينزعج من أشياء تبدو لي ترفًا.
عندما يهاجر السوداني إلى مصر، غالباً ما يدخل بطريقة غير نظامية أو عبر طرق وعرة محفوفة بالمخاطر. يصل وهو منهك، ومع ذلك، حين يستأجر شقة خالية من الأثاث، وينام على البلاط، لا يشتكي، بل يقول “الحمد لله”. لا يشتري فرشًا، لا يطلب أكثر من السقف، ويشكر الله. تلك لحظة إدراكية فريدة، تظهر التكيف القهري والرضا النسبي: إدراك أن القليل هنا أفضل من انعدام الأمان هناك.
في هذا السياق، تتجلى التحولات بوضوح. السوداني يرى في الخبز المتوفر في المتاجر المصرية نعمة كبرى، وكأنه حصل عليه مجاناً. يقول في نفسه: “دي بلاد فيها خبز بدون بطاقة، بدون صف طويل… دي نعمة.” أما المواطن المصري، فيراه غلاءً وضغطاً. هنا تتبدى فجوة الإدراك، فكل شعب يقيس ظروفه بذاكرته، لا بواقع الآخر.
من داخل السودان، نعايش أزمة التعليم كجرح نازف آخر. كثير من الآباء احتسبوا الأيام الفعلية التي تلقى فيها أبناؤهم تعليمًا حقيقيًا، فوجدوا أنها لا تتجاوز الشهرين في الصف الأول، وثلاثة أشهر في الصف الثاني. الخوف من المظاهرات، من الرصاص، من الفوضى، كلها عوامل تمنع استقرار العملية التعليمية. جلسنا كآباء نتحاور، نبحث عن مخرج. وعندما ذهبنا إلى الأستاذ التاج، مشرف فصل بمدرسة العمارات أساس بنين، قال لنا:
“لو بيتك ولع وما في مطافي، أول حاجة تطلعها الأشياء الغالية – العربي، الرياضيات، الإنجليزي – لأنها هي القواعد اللي ولدك حيحتاجها في المستقبل.”
كانت كلماته دقيقة، تمثل رؤية تربوية عملية في وقت يغيب فيه التخطيط المنتظم. فمرحلة التأسيس لا تحتمل التهاون، إذ هي التي تزرع في التلاميذ أساسًا متينًا تقوم عليه المراحل التعليمية اللاحقة. أي خلل في هذه المرحلة ينعكس لاحقًا على قدرة الطفل في الفهم، والتحليل، والتكيف مع محيطه الاجتماعي والاقتصادي.
التحليل النفسي والاجتماعي:
تُظهر هذه التجارب المتكررة أن الإنسان السوداني يمتلك قدرة فريدة على إعادة تعريف المعاناة. فعندما تضيق السبل، يتحول الألم إلى طاقة صبر، واليأس إلى شكل من أشكال الإيمان العملي. إنها آلية دفاع نفسي لكنها في الوقت نفسه شكل من الذكاء الجمعي في إدارة الندرة. فالرضا النسبي ليس ضعفاً، بل توازن نفسي يسمح بالاستمرار في ظروف لا تُحتمل.
علم النفس الاجتماعي يفسر ذلك بما يُعرف بـ”المرونة التكيفية” (Adaptive Resilience)، وهي قدرة الإنسان على تعديل توقعاته لتتوافق مع الواقع دون أن يفقد توازنه النفسي أو إحساسه بالقيمة الذاتية. بينما يضيف علم الاجتماع أن هذه التحولات ليست فردية فقط، بل تتجذر في البنية الجماعية عبر الثقافة، والعادات، وشبكات التضامن الاجتماعي.
ومع ذلك، فإن خطر التكيف القهري يكمن في تحوّله إلى تبلّد جماعي، أي أن يعتاد المجتمع الألم إلى درجة يفقد معها الحس النقدي والرغبة في التغيير. وهنا يظهر التحدي الحقيقي: كيف نُحافظ على التكيف الإيجابي دون أن نفقد القدرة على الحلم والإصلاح؟
التوصيات:
1. تأهيل اللاجئين نفسيًا واجتماعيًا عبر برامج دعم ممنهجة تساعدهم على تجاوز صدمة الحرب دون أن يتحول التكيف إلى استسلام.
2. تعزيز التعليم الأساسي في مناطق اللجوء باعتباره أداة للحفاظ على الهوية والكرامة الإنسانية، وتأسيس مستقبل مستقر لأبناء اللاجئين.
3. تشجيع الدراسات النفسية الميدانية حول اللاجئين السودانيين لفهم آليات التكيف والرضا، وتقديم نماذج للتدخل الإنساني تراعي الثقافة المحلية.
4. تفعيل دور الإعلام السوداني والمجتمعات المحلية في تصحيح الصور النمطية عن اللاجئ، وإبرازه كقوة فاعلة وليس عبئًا.
5. الحفاظ على الكرامة والهوية الجمعية التي تحمي المجتمع من الذوبان والانكسار.
إن الإنسان السوداني، في الداخل والخارج، يعيش اليوم حالة من إعادة التكوين الذاتي. الحرب لم تسلبه القدرة على الحلم، لكنها أجبرته على إعادة تعريف معنى الحياة ذاتها. لقد صار الرغيف رمزًا للصبر، والسكن البسيط معجزة بقاء، والتعليم أملًا استراتيجياً للمستقبل.
إن دراسة تحولات الإدراك والمعيشة تحت الضغط لا تهدف إلى توثيق المأساة فقط، بل إلى فهم كيف يصنع الإنسان من المحنة مشروع وعيٍ جديد، وكيف يولد من رحم الشدة الإنسان القادر على إعادة بناء وطنه دون أن يبيع أرضه ولا ذاكرته ولا كرامته.