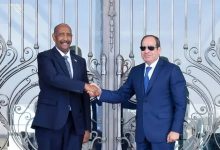الدعم المعنوي: استثمار استراتيجي في رأس المال البشري
يشكل الدعم المعنوي أحد أهم أدوات التحفيز غير المادي، وهو لا يُعد مجرّد سلوك أخلاقي أو ديني فحسب، بل هو مدخل استراتيجي فاعل في بناء القدرات البشرية وتحقيق التميز المؤسسي. فالتحفيز الإيجابي يُسهم في رفع الروح المعنوية، وتعزيز الانتماء، وخلق بيئة محفزة على الإنتاج والابتكار.
وقد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم هذا المبدأ في أبعاده النفسية والاجتماعية والقيادية، فكان دائم الحث على التفاؤل، يقول: “يُعجبني الفأل الصالح”، ويؤكّد: “تفاءلوا بالخير تجدوه”. ولم يكن ذلك مجرد تعبير عاطفي، بل توجيه عملي لإعادة تشكيل العقلية نحو الأمل والثقة، وهو ما تؤكده اليوم علوم الإدارة والاقتصاد السلوكي في علاقتها بالإنتاجية والتحفيز.
بعد إعلان نتيجة الشهادة السودانية لعام 2012م، سادت حالة من الحزن وخيبة الأمل بين كثير من الأسر، خاصة ممن لم يتمكن أبناؤهم من تحقيق نسب تؤهلهم لدخول كليات الطب. كانت النسب ما بين 90% و75% تُعد صادمة في نظر أولئك الآباء الذين اختصروا النجاح في تخصصٍ بعينه. غير أن موقفًا بسيطًا في حينا لفت انتباهي وغير نظرتي تمامًا:
ابن جارنا أحرز نسبة متدنية للغاية، 52% فقط، رغم أنه كان يطمح إلى دراسة الطب. لكن والده استقبل النتيجة بفرح كبير، وزيّن المنزل بالأضواء، وأقام وليمة ضخمة ذبح فيها الذبائح ووزع الحلوى والتورتات. حين استغرب أحد الجيران وقال له: “دي نسبة يُحتفل بيها؟”، أجابه بابتسامة واثقة: “ولدي ناجح، وأفضل من أن يرسب.” وقد شارك الجميع في تهنئته، لا للنتيجة، بل للنجاح نفسه.
مرت السنوات، وقابلت ذلك الشاب بعد فترة وسألته عن حاله، فأخبرني أنه التحق بإحدى الجامعات الخاصة ودرس تقنية المعلومات (IT)، وبعد تخرجه سافر إلى الخليج، وحصل على وظيفة ممتازة، ثم عاد وأسس مشروعًا ضخمًا مع والده. قصة تُلخّص أثر الدعم المعنوي حين يُبنى على الحكمة، لا على المقارنة أو الإحباط.
وفي السياق ذاته، تبرز القصة الشهيرة للعالم توماس إديسون، الذي طُرد من مدرسته في طفولته بعد أن وصفه المعلم بأنه “غبي لا يصلح للتعلم”. وعندما عاد إلى بيته باكيًا يحمل رسالة من المدرسة، قرأتها له والدته بصوت هادئ وقالت إنها تقول: “ابنك عبقري، وهذه المدرسة صغيرة على قدراته، لذلك سنعلمه في البيت.”
لم يكن إديسون يعلم أن الحقيقة مختلفة، فقد أخفت عنه والدته قسوة الكلمات التي وصمته بالفشل، واستبدلتها بدعم نفسي صادق. بعد سنوات، عندما أصبح من أعظم مخترعي التاريخ، وجد تلك الرسالة في أوراقها القديمة، وقرأ الحقيقة بنفسه، فبكى وكتب: “كانت أمي تصنع مني عبقريًا وهي لا تدري.”
تلك الأم لم تُنكر ضعف ابنها، لكنها آمنت بقدرته على النمو، فحوّلت الإخفاق إلى طاقة دافعة. إنها أروع صورة للدعم المعنوي الذي يصنع الفرق بين الانكسار والانتصار.
في السياق الاقتصادي والإداري، أثبتت الدراسات الحديثة أن المؤسسات والمجتمعات التي توظف الدعم المعنوي كجزء من استراتيجياتها التنموية تحقق نتائج أفضل على مستوى الأداء الفردي والجماعي، وتنجح في استثمار طاقاتها البشرية بصورة أكثر استدامة. أما اجتماعيًا، فإن احترام التفاوت في القدرات، وتقدير الجهد المبذول، لا النتيجة المجردة، يُسهم في تعزيز الثقة بالنفس والانتماء الوطني.
التوصيات والرؤية التربوية
1. إدماج الدعم المعنوي في السياسات التربوية: عبر تدريب المعلمين وأولياء الأمور على مهارات التشجيع الإيجابي والتغذية الراجعة البنّاءة.
2. تحويل الفشل إلى تجربة تعلم: غرس ثقافة أن الخطأ ليس نهاية الطريق، بل خطوة نحو النضج والتحسين.
3. تفعيل برامج التحفيز غير المادي في المؤسسات: كالتقدير العلني، والإشادة بالجهد، وربط التميز بالابتكار لا بالمقارنة.
4. ترسيخ مفهوم “الإنسان أولًا” في الخطط التنموية والتعليمية والإدارية، بحيث يُنظر إلى الفرد كقيمة مضافة لا كرقم في منظومة الأداء.
5. الاستفادة من علم النفس الإيجابي في بناء بيئات عمل وتعليم تقوم على الدعم، لا على الإقصاء أو المقارنة.
إن الدعم المعنوي ليس مجاملة عاطفية، بل أداة استراتيجية تُسهم في إعادة توجيه الطاقات، وتمكين الأفراد من تجاوز الإحباطات العابرة. وهو استثمار طويل الأمد في رأس المال البشري، تُجنى ثماره حين تتكامل المنظومة التربوية والإدارية والاقتصادية والاجتماعية في رؤية واحدة:
الإنسان أولًا، والدعم المعنوي مفتاح بناءه.
الكلمة الطيبة قد لا تغيّر الواقع فورًا، لكنها تغيّر الإنسان الذي يغيّر الواقع.
ومن يُحسن القول والدعم، يُسهم في بناء أمةٍ متصالحة مع ذاتها، تؤمن أن النجاح الحقيقي لا يُقاس بالدرجات ولا بالمناصب، بل بقدرتنا على أن نُشعل الأمل في قلبٍ خافت نوره.