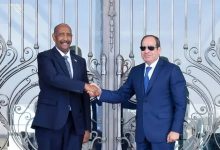مياه الحياة: نحو استراتيجية متكاملة لتنمية الثروة الحيوانية في السودان
بقلم : د. محمد صلاح علي الفكي

مياه الحياة: نحو استراتيجية متكاملة لتنمية الثروة الحيوانية في السودان
> “حين تتدفق المياه، تنمو الحياة… وتنتعش القطاعات كافة من المزرعة إلى الأسواق العالمية.” في حديث عميق مع الخبير الاقتصادي والتربوي بوزارة التربية والتعليم بدولة قطر، الأستاذ محمد صالح مشاور، استوقفتني مقاربته المتكاملة لعلاقة وفرة المياه بالتنمية الشاملة، لا سيما في قطاع الثروة الحيوانية الذي يمثل موردًا حيويًا مهملًا رغم قدرته على الدفع بالنمو الاقتصادي وتحقيق الأمن الغذائي وزيادة الصادرات.
إن وفرة المياه واستدامتها ليست مسألة بيئية فقط، بل مفتاح لتحول اقتصادي واجتماعي وإداري شامل. فغياب الماء في المراعي الطبيعية لا يعني فقط جفاف العشب، بل هلاك القطعان، وارتفاع نسب الإجهاض، وضعف جودة اللحوم والألبان، وفقدان فرص تصديرية كان يمكن أن تضخ عملات صعبة في الاقتصاد السوداني.
وقد أوضح الأستاذ مشاور أن الإبل – رمز الصبر والتحمل – لا تشرب سوى مرة كل سبعة أيام في حر الصيف، فيما تحتاج الأغنام للشرب كل خمسة أيام. ومع بُعد موارد المياه عن المراعي، تضطر القطعان إلى التنقل المرهق، ما يؤدي إلى هزال، ونفوق، وانخفاض الخصوبة، وزيادة الأمراض، وانهيار الدورات الإنتاجية. وكل ذلك يحدث في ظل غياب خدمات بيطرية ميدانية فاعلة، ومحدودية التدخلات الحكومية المنظمة.
لكن – وهنا بيت القصيد – توفير المياه بشكل استراتيجي ومدروس يمكن أن يحدث تحولًا نوعيًا في القطاع الحيواني. فوفقًا لتقديرات وتجارب الرعاة الممارسين، يمكن مضاعفة أعداد الأغنام بنسبة 90–100% في الموسم الواحد إذا ما توفرت ثلاثة عناصر أساسية:
1. مياه نقية وقريبة من مواقع الرعي.
2. استزراع أعلاف عالية الجودة تلائم البيئة المحلية.
3. خدمات بيطرية متنقلة ومدعومة من الدولة.
ولعلّ هذا يدفعنا إلى طرح سؤال جوهري:
لماذا لا نُدرج قضية “استدامة المياه” كعنصر مركزي في سياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وليس فقط البيئية؟
إن العلاقة بين الماء والماشية ليست علاقة مورد ومستهلك، بل علاقة دفع اقتصادي شامل، حيث تؤدي وفرة المياه إلى:
زيادة الإنتاجية وتحسين جودة اللحوم والألبان.
تقليل الاعتماد على الاستيراد.
تحفيز قيام صناعات تحويلية (جلود، ألبان، لحوم مصنعة).
تقوية التوازن البيئي والاجتماعي في الريف، مما يحدّ من الهجرة للمدن.
دعم صادرات الماشية وجلب النقد الأجنبي.
ولتحقيق ذلك، نحن بحاجة إلى خطة استراتيجية وطنية تُعطي أولوية لمسألة المياه في المراعي، عبر:
إنشاء محطات مياه دائمة وموسمية قرب مناطق الرعي.
استخدام تقنيات حصاد المياه (مثل الحفائر والسدود الرملية).
توظيف نظم الإنذار المبكر لتحديد أوقات ومواقع الشح المائي.
ربط مشاريع المياه بخطط تنمية الريف وتمكين المجتمعات المحلية.
تأسيس وحدة بحثية مستقلة لدراسة أثر الماء على الثروة الحيوانية والتخطيط الموسمي.
فإن قضية المياه لا تنفصل عن التنمية، ولا يمكن حصرها في وزارات البيئة أو الري فقط، بل يجب أن تُصبح قضية استراتيجية وطنية عابرة للقطاعات والتخصصات، يُسهم فيها الاقتصادي، والبيطري، والمهندس، والراعي، والمصدر، والخبير القانوني.
فحين تتوفر المياه، تولد القيمة، وتتحرك الأسواق، وينتعش الريف، وتتراجع الفجوات الاجتماعية. وحين تُهدر المياه أو تُهمّش، لا يُهدر معها فقط مورد طبيعي، بل تُهدر فرص أمة بأكملها. > “لا صحة للإنسان بدون صحة الحيوان، ولا اقتصاد بلا ماء، ولا استراتيجية دون احترام الواقع.”
🔷 من وجع الرعاة إلى طاولة الاستراتيجيات
ومن قلب الهشاشة المناخية والجغرافية والاجتماعية، ينهض راعي الإبل والأغنام حاملًا همّ الماء والمرعى قبل أن يفكر في السوق والتصدير. لا أحد يهتم بالعافية البيطرية، رغم أن الحيوان يمرض ويعاني مثل البني آدم تمامًا. يمرض الحيوان، يهزل، يسقط، ويُجهض، لأن الماء بعيد، والوباء قريب.
🔷 الماء: البنية التحتية غير المرئية للثروة الحيوانية
الوفرة المائية ليست ترفًا زراعيًا بل عصب الحياة الاقتصادية. فحين يتوفر الماء، تنخفض نسبة النفوق في الأغنام والإبل من 30–40% في بعض المواسم إلى أقل من 5%. الإبل تشرب كل 7 أيام في حرّ الصيف، والأغنام كل 5 أيام، ولكن حين يبتعد المورد عن المراعي، تبدأ معركة البقاء.
الفاقد الاقتصادي من ندرة المياه في موسم واحد يتجاوز عشرات الملايين من الريالات/الدولارات، نتيجة:
هزال وفقدان الوزن (انخفاض الجدوى التجارية).
النفوق.
الإجهاض الموسمي (تراجع دورة الإنتاج).
اضطرار الرعاة لبيع القطيع مبكرًا بأسعار بخسة.
🔷 علاقة الارتباط والدفع بين الماء والإنتاج الحيواني
زيادة وفرة المياه → تحسين صحة الحيوان → زيادة الإنتاج والخصوبة → تحسين جودة الصادر.
استزراع الأعلاف المناسبة (برسيم، ذرة شامية، أو أعشاب محلية) → تقليل الاعتماد على الأعلاف المستوردة → خفض تكلفة الإنتاج.
بناء حصاد مياه في مناطق الرعي (سدود ترابية، حفائر، آبار محمية) → استقرار المجتمعات الريفية → تحسين فرص التعليم والصحة والتنمية المحلية.
🔷 التحول الاستراتيجي: من تصدير الحيوان الحي إلى القيمة المضافة
ضمن رؤية الاستراتيجية ربع القرنية، لا بد من إصلاح المسار التقليدي للتصدير. الاستراتيجية الوطنية المقترحة:
منع تصدير الحيوان الحي عدا موسم الهدي.
التوسع في إنشاء مسالخ حديثة بمعايير دولية قرب مناطق الإنتاج.
تطوير سلاسل التبريد والنقل.
توطين التصنيع الغذائي (لحوم مبردة، مصنعات جلد، سماد عضوي).
🔷 الصحة البيطرية: الخط الدفاعي الأول للصادر
توفير اللقاحات، البيطريين المؤهلين، والمراكز البيطرية المتنقلة، يجب أن يُعامل كأولوية قومية. فبدون عافية الحيوان، لا وجود لاقتصاد صادر.
> هل نعلم أن عدم وجود تدخل بيطري في أوقات الجفاف يضاعف النفوق والإجهاض بنسبة 200%؟
وهل ندرك أن التدخل الوقائي أرخص بعشرين مرة من علاج قطيع موبوء؟
🔷 دعوة لبحث علمي ميداني من أرض الرعاة
نقترح إطلاق دراسة علمية استراتيجية بعنوان:
> “أثر استدامة المياه على جودة وزيادة الثروة الحيوانية في السودان وقطر: دراسة مقارنة من واقع الرعاة”
🔷 الوقت ليس في صالحنا. لا بد من تكامل الجهود: وزارة الثروة الحيوانية، المياه، الزراعة.
💧 حصاد المياه: من المطر إلى التنمية
> “الماء ليس موردًا طبيعيًا فقط… بل هو سياسة، وأمن قومي، ومحرك تنموي شامل.”
يُعد حصاد مياه الأمطار من أقدم الوسائل التي استخدمتها البشرية لمواجهة ندرة المياه، لكنه اليوم يعود إلى الواجهة بوصفه خيارًا استراتيجيًا لدول تعاني من شحّ الموارد، أو سوء إدارتها، أو تأثيرات تغيّر المناخ. وفي السودان، حيث تتساقط كميات معتبرة من الأمطار سنويًا تتجاوز 400 مليار متر مكعب، لا يزال غياب البنية المؤسسية والتقنية لحصاد المياه يمثل ثغرةً تنموية خطيرة.
▪️ من الفرصة إلى الفاقد
بينما تهرع دول العالم إلى تطوير تقنيات حصاد المياه، من الأسطح إلى السدود الصغيرة إلى الحفائر الذكية، يفقد السودان سنويًا كميات ضخمة من المياه إما بالجريان السطحي إلى دول الجوار، أو بالتبخر، أو بانجراف التربة، دون تحويلها إلى قيمة إنتاجية.
فالماء الذي لا يُحصد لا يسقي، والمورد الذي لا يُدار لا يُثمر.
▪️ البُعد التنموي متعدد القطاعات
حصاد المياه ليس مجرد مشروع بيئي، بل هو قاطرة تنموية شاملة، تمتد آثاره إلى:
1. الزراعة: التوسع في الزراعة المطرية المنظمة والري التكميلي.
2. الثروة الحيوانية: تقليل النفوق، تقوية القطيع، رفع الخصوبة، تحسين جودة الصادر.
3. المياه الجوفية: تغذية الخزانات وحماية مصادر المياه العميقة.
4. الأمن الغذائي: زيادة الإنتاج المحلي وخفض فاتورة الواردات.
5. استقرار المجتمعات: تقليل النزوح، وتعزيز استقرار سكان الريف والبدو.
6. الصحة العامة: تقليل انتشار الأمراض المرتبطة بالمياه الراكدة والمستنقعات.
7. الاقتصاد الكلي: توفير فرص عمل، وتقليل الضغط على الموازنة العامة، وتحفيز الاستثمار.
▪️ دروس من العالم
الهند: طبّقت برامج إلزامية لحصاد مياه الأسطح في المناطق الحضرية.
سنغافورة: تحوّلت من بلد لا يملك مصادر مياه إلى دولة رائدة في “إعادة استخدام الأمطار”.
البرازيل: أنشأت آلاف الخزانات المجتمعية في المناطق شبه القاحلة ضمن خطة “صهريج لكل بيت”.
تركيا: ربطت سياسات الحصاد المائي بإستراتيجيات الأمن الغذائي والطاقة.
▪️ المعوقات في السودان
ضعف التنسيق المؤسسي بين وزارات الزراعة، الري، البيئة، والحكومات المحلية.
قلة التمويل وانعدام الشراكات الحقيقية مع المجتمعات المحلية.
ضعف القدرات الفنية والبيانات المناخية الدقيقة.
غياب التشريعات الملزمة والتصاميم الموحدة.
▪️ من التحدي إلى المشروع الوطني
إن تحويل حصاد المياه من نشاط موسمي إلى مشروع وطني استراتيجي يتطلب:
✅ سن قانون قومي لحصاد المياه وربطه بسياسات الأمن المائي والغذائي.
✅ إنشاء هيئة عليا لحصاد المياه ضمن وزارة مستقلة أو مجلس تنسيقي أعلى.
✅ دعم البحث العلمي التطبيقي في الجامعات والمراكز الوطنية.
✅ تحفيز المجتمعات المحلية وتدريبها على صيانة منشآت الحصاد.
✅ دمج حصاد المياه في خطط التعليم، والصحة، والإسكان، والتخطيط العمراني.
▪️ لن تُبنى نهضة على أرضٍ يعجز أهلها عن جمع نعمة المطر. فالسودان لا يفتقر إلى الماء، بل إلى الإدارة الرشيدة له. وحين نصنع من كل قطرة مطر مشروعًا للحياة، نكون قد بدأنا فعليًا في بناء دولة المستقبل. التخطيط، القطاع الخاص، والجهات الدولية. فالاستثمار في الماء والعافية البيطرية هو استثمار في أمننا الغذائي وصادرنا الاقتصادي وهويتنا المجتمعية.